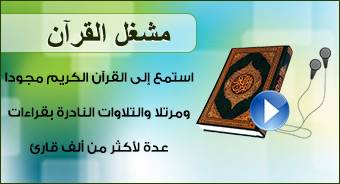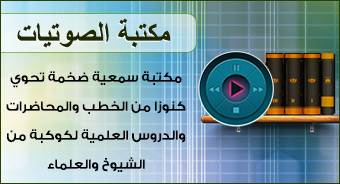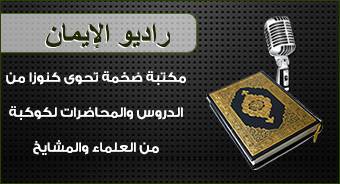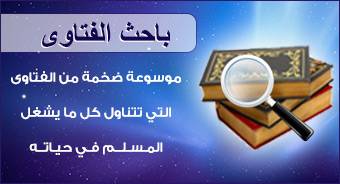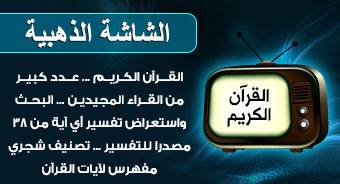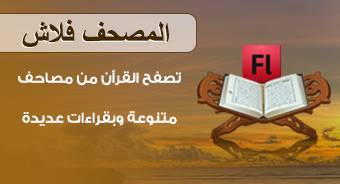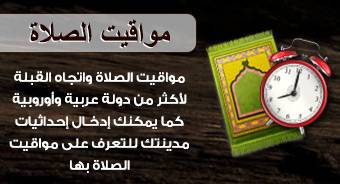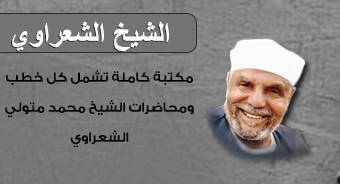|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **
1- عن زيد بن خالد الجهني: (أن رجلًا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل اللَّه ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين). رواه الخمسة إلا الترمذي. 2- وعن جابر بن سمرة: (أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. قوله: (فقال صلوا على صاحبكم) فيه جواز الصلاة على العصاة وأما ترك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلول كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه. قوله: (ففتشنا متاعه) الخ فيه معجزة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال. قوله: (ما يساوي درهمين) فيه دليل على تحريم الغلول وإن كان شيئًا حقيرًا وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها. قوله: (بمشاقص) جمع مشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش كذا في القاموس. قوله: (فلم يصل عليه) فيه دليل لمن قال إنه لا يصلى على الفاسق وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي فقالوا لا يصلى على الفاسق تصريحًا أو تأويلًا ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه في الباغي والمحارب ووافقهم الشافعي في قول له في قاطع الطريق وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنما لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس وصلت عليه الصحابة. ويؤيد ذلك ما عند النسائي بلفظ: (أما أنا فلا أصلي عليه) وأيضًا مجرد الترك لو فرض أنه لم يصل عليه هو ولا غيره لا يدل على الحرمة المدعاة. ويدل على الصلاة على الفاسق حديث: (صلوا على من قال لا إله إلا اللَّه) وقد تقدم الكلام عليه في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة. الصلاة على من قتل في حد 1- عن جابر: (أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال: أبك جنون قال: لا. قال: أحصنت قال: نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خيرًا و صلى عليه). رواه البخاري في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقالوا: (ولم يصل عليه) ورواية الإثبات أولى وقد صح عنه عليه السلام أنه صلى على الغامدية وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه). حديث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عنه وقال: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري وصلى عليه وعلل بعضهم هذه الزيادة أعني قوله (فصلى عليه) بأن محمد بن يحيى لم يذكرها وهو أضبط من محمود بن غيلان. قال: وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب وقال غيره كذا روي عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكروا الزيادة وقال: ما أرى مسلمًا ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء وقد خالف محمودًا أيضًا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودًا وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل. وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة. وقال البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال: (فصلى عليه) وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه انتهى. وعلى هذا تكون زيادة قوله (وصلى عليه) شاذة ولكنه قد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة وهي ههنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث وأما باعتبار ما وقع عند أحمد وأهل السنن من أنه لم يصل عليه فرواية الصلاة أرجح من جهات: الأولى: كونها في الصحيح. الثانية: كونها مثبتة. الثالثة: كونها معتضدة بما أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين: (أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: إنها قد زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وليها فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها) الحديث. وبما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث بريدة أن امرأة من غامد أتت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث عمران وقال: (فأمر بها فصلى عليها) الحديث. وبما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجم امرأة) وفيه: (فلما طفئت أخرجها فصلى عليها) وفي إسناده مجهول. ومن المرجحات أيضًا الاجتماع على الصلاة على المرجوم. قال النووي: قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اهـ. ويتعقب بأن الزهري يقول لا يصلى على المرجوم وقتادة يقول لا يصلى على ولد الزنا وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه. ـ ومن جملة ـ المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ففي إسناده مجاهيل وبقية الكلام على حديث ماعز والغامدية يأتي إن شاء اللَّه في الحدود وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام. الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 1- عن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعًا) وفي لفظ: (قال: توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه فصففنا خلفه فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليه ونحن صفوف). متفق عليهما. 2- وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات). رواه الجماعة وفي لفظ: (نعى النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة) رواه أحمد. 3- وعن عمران بن حصين: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال: فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قوله: (على أصحمة) قال في الفتح: وقع في جميع الروايات التي اتصلت بنا من طريق البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين. ووقع في مصنف ابن أبي شيبة صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف قال: وهو غلط. وحكى الكرماني أن في بعض النسخ صحبة بالموحدة بدل الميم انتهى. وهو اسم النجاشي. قال ابن قتيبة وغيره: معناه بالعربية عطية والنجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء كياء النسب وقيل بالتخفيف ورجحه الصنعاني لقب لمن ملك الحبشة وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه. قال المطرزي وابن خالويه وآخرون: إن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين ومن ملك الحبشة النجاشي ومن ملك الروم قيصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك الترك خاقان ومن ملك القبط فرعون ومن ملك مصر العزيز ومن ملك اليمن تبع ومن ملك حمير القيل بفتح القاف وقيل القيل أقل درجة من الملك. قوله: (فكبر عليه أربعًا) فيه دليل على أن المشروع في تكبير الجنازة أربع وسيأتي الكلام في ذلك. قوله: (وخرج بهم إلى المصلى) تمسك به من قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجد وسيأتي البحث في ذلك وقد استدل بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد. قال في الفتح: وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر. وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه في البحر عن العترة أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا. قال الحافظ: وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه القصة بأعذار منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه واستحسنه الروياني وترجم بذلك أبو داود في السنن فقال باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. قال الحافظ: وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد انتهى. وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف والمحقق المقبلي واستدل له بما أخرجه الطيالسي وأحمد وابن ماجه وابن قانع والطبراني والضياء المقدسي. وعن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه) ومن الأعذار قولهم إنه كشف له صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى رآه فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك. قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثله هذا من جهة المانع. قال الحافظ: وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن ابن عباس قال: (كشف للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه) ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: (فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه) ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. ومن الأعذار أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على ميت غائب غيره وتعقب بأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو مات بالمدينة والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك في الاستيعاب. وروي أيضًا عن أبي أمامة الباهلي مثل هذه القصة في حق معاوية بن مقرن وأخرج مثلها أيضًا عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزني ثم قال بعد ذلك: أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية ولو أنها في الأحكام لم يكن شيء منها حجة. وقال الحافظ في الفتح متعقبًا لمن قال أنه لم يصل على غير النجاشي قال: وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه انتهى. وقال الذهبي: لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية وكذلك تكلم فيه البخاري. وقال ابن القيم: لا يصح حديث صلاته صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معاوية بن معاوية لأن في إسناده العلاء بن يزيد قال ابن المديني: كان يضع الحديث وقال النووي مجيبًا على من قال بأن ذلك خاص بالنجاشي: إنه لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله. وقال ابن العربي: قال المالكية ليس ذلك إلا لمحمد قلنا وما عمل به محمد تعمل به أمته يعني لأن الأصل عدم الخصوص قالوا طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثًا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع ولئن سلمنا فكان غائبًا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. ـ والحاصل ـ أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها وهو أيضًا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر. 4- وعن ابن عباس قال: (انتهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا). 5- وعن أبي هريرة: (أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا ففقدها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات قال: أفلا آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال: دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اللَّه ينورها لهم بصلاتي عليهم). متفق عليهما وليس للبخاري: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة) إلى آخر الخبر. 6- وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على قبر بعد شهر). 7- عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على ميت بعد ثلاث). رواهما الدارقطني. 8- وعن سعيد بن المسيب: (أن أم سعد ماتت والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر). رواه الترمذي. حديث ابن عباس الآخر أخرج الدارقطني الرواية الأولى منه من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس. وأخرجه أيضًا البيهقي وأخرج الثانية من طريق سفيان عن الشيباني به. ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني به أنه صلى بعد دفنه بليلتين. وحديث سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي. قال الحافظ: وإسناده مرسل صحيح. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس وفي إسناده سويد بن سعيد. ـ وفي الباب ـ عن أبي هريرة عند الشيخين بنحو حديث الباب. وعن أنس عند البزار نحوه. وعن أبي أمامة بن سهل عند مالك في الموطأ نحوه أيضًا. وعن زيد بن ثابت عند أحمد والنسائي نحوه أيضًا. وعن أبي سعيد عند ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عقبة بن عامر عند البخاري. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر عنده أيضًا. وعن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عند النسائي. وعن أبي قتادة عند البيهقي أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على قبر البراء. وفي رواية بعد شهر. قال حرب الكرماني. ـ وفي الباب ـ أيضًا عن عامر بن ربيعة وعبادة وبريدة بن الحصيب. قوله: (إلى قبر رطب) أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه. قوله: (وكبر أربعًا) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة أربع وسيأتي. قوله: (أن امرأة سوداء) سماها البيهقي أم محجن وذكر ابن منده في الصحابة خرقاء اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد فيمكن أن يكون اسمها خرقاء وكنيتها أم محجن. قوله: (أو شابًا) هكذا وقع الشك في ألفاظ الحديث وفي حديث أبي هريرة الجزم بأن صاحبة القصة امرأة وجزم بذلك ابن خزيمة في روايته لحديث أبي هريرة. قوله: (كانت تقم) بضم القاف أي تجمع القمامة وهي الكناسة. قوله: (ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة) الخ احتج بهذه الرواية من قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو النخعي ومالك وأبو حنيفة والهادوية قالوا إن قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإن اللَّه ينورها بصلاتي عليهم يدل على أن ذلك من خصائصه وتعقب ذلك ابن حبان فقال في ترك إنكاره صلى اللَّه عليه وآله وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه وتعقب هذا التعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلًا للأصالة. ـ ومن جملة ـ ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت بيَّن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد. قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد انتهى. وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل ومجرد كون اللَّه ينور القبور بصلاته صلى اللَّه عليه وآله وسلم على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره لا سيما بعد قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن وأما من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق وجعل الدفن مسقطًا لهذا الفرض محتاج إلى دليل وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الجمهور كما قال ابن المنذر وبه قال الناصر من أهل البيت. وقد استدل بحديث الباب على رد قول من فصل فقال يصلي على قبر من لم يكن قد صلى عليه قبل الدفن لا من كان قد صلى عليه لأن القصة وردت فيمن قد صلى عليه والمفصل هو بعض المانعين الذين تقدم ذكرهم واختلفوا في أمد ذلك فقيده بعضهم إلى شهر. وقيل ما لم يبل الجسد وقيل يجوز أبدًا. وقيل إلى اليوم الثالث. وقيل إلى أن يترب. ـ ومن جملة ـ ما اعتذر به المانعون من الصلاة على القبر أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة مع إمكان صلاة الأولى وهذا تمحل لا ترد بمثله هذه السنة لا سيما مع ما تقدم من صلاته صلى اللَّه عليه وآله وسلم على البراء بن معرور مع أنه مات والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم غائب في مكة قبل الهجرة وكان ذلك بعد موته بشهر. وعلى أم سعد وكان أيضًا عند موتها غائبًا وعلى غيرهما.
1- عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين). متفق عليه. ولأحمد ومسلم: (حتى توضع في اللحد) بدل تدفن وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق). ـ وفي الباب ـ عن عائشة عند البخاري. وعن ثوبان عند مسلم. وعن عبد اللَّه بن مغفل عند النسائي. وعن أبي سعيد عند أحمد. وعن ابن مسعود عند أبي عوانة. قال الحافظ: وأسانيده هذه صحاح. وعن أُبيِّ بن كعب عند ابن ماجه. وعن ابن مسعود عند البيهقي في الشعب وأبي عوانة. وعن أنس عند الطبراني في الأوسط. وعن واثلة بن الأسقع عند ابن عدي. وعن حفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال. قال الحافظ: وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. قوله: (من شهد) في رواية للبخاري: (من شيع) وفي أخرى له: (من تبع) وفي رواية لمسلم: (من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن) فينبغي أن تكون هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات فالتشييع والشهادة والإتباع يعتبر في كونها محصلة للأجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت الميت. ويدل على ذلك ما وقع في رواية لأبي هريرة عند البزار بلفظ: (من أهلها) وما عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: (فمشى معها من أهلها) ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك جزم الطبري. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى. واستدل بما عند مسلم بلفظ: (من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط) وبما عند أحمد عن أبي هريرة: (ومن صلى ولم يتبع فله قيراط) فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع إتباع قال: ويمكن أن يحمل الإتباع هنا على ما بعد الصلاة انتهى. وهكذا الخلاف في قيراط الدفن هل يحصل بمجرد الدفن من دون إتباع أو لا بد منه. قوله: (حتى يصلى عليها) قال في الفتح: اللام للأكثر مفتوحة. وفي بعض الروايات بكسرها ورواية الفتح محمولة عليها فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له انتهى. قال ابن المنير: إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلًا وشيع ثم انصرف بغير صلاة وذلك لأن الإتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين إما الصلاة وإما الدفن فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب على المقصود وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب وقد روى سعيد بن منصور عن مجاهد أنه قال: إتباع الجنازة أفضل النوافل وفي رواية عبد الرزاق عنه إتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. قوله: (فله قيراط) بكسر القاف قال في الفتح: قال الجوهري: القيراط نصف دانق قال والدانق سدس الدرهم فهو على هذا نصف سدس الدرهم كما قال ابن عقيل وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته فضرب له المثل بما يعلم ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرًا نبه على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك فقال مثل أحدكما كما في بعض الروايات وفي أخرى أصغرهما مثل أحد. وفي حديث الباب مثل الجبلين العظيمين. قوله: (ومن شهدها حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب. وقد وردت الأخبار بكل ذلك فعند مسلم: (حتى يفرغ منها) وعنده في أخرى: (حتى توضع في اللحد) وعنده أيضًا: (حتى توضع في القبر) وعند أحمد: (حتى يقضي قضاؤها) وعند الترمذي: (حتى يقضي دفنها) وعند أبي عوانة: (حتى يسوى عليها) أي التراب. وقيل يحصل القيراط بكل من ذلك ولكن يتفاوت. والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن وتسوية التراب بالمقيدة بهما. قوله: (مثل الجبلين) في رواية: (مثل أحد) وفي رواية للنسائي: (كل واحد منهما أعظم من أحد) وعند مسلم أصغرهما مثل أحد. وعند ابن عدي أثقل من أحد فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد وأن المراد به زنة الثواب المترتب على ذلك. قوله: (حتى توضع في اللحد) استدل به المصنف على أن اللحد أفضل من الشق وسيأتي الكلام على ذلك . 2- وعن مالك بن هبيرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف). رواه الخمسة إلا النسائي. 3- وعن عائشة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. 4- وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون باللَّه شيئًا إلا شفعهم اللَّه فيه). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 5- وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال اللَّه تعالى قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون). رواه أحمد. حديث مالك بن هبيرة في إسناده محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن مالك وفيه مقال معروف إذا عنعن. وقد حسن الحديث الترمذي. وقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا ورواية هؤلاء أصح عندنا قال: ـ وفي الباب ـ عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة ثم ذكر حديث عائشة بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من طريق ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. وعن أحمد بن منيع وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد عن عائشة ثم قال: حسن صحيح وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه. قال النووي: من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة. وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن ماجه. وحديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم من طريق حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا. ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه وقال ثلاثة بدل أربعة. وفي إسناده رجل لم يسم وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي. قوله: (يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف) فيه دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له وأقل ما يسمى صفًا رجلان ولا حد لأكثره. قوله: (يبلغون مائة) فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز وقد قيد ذلك بأمرين: الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك باللَّه شيئًا كما في حديث ابن عباس قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. قال النووي: ويحتمل أن يكون النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. قال: ويحتمل أيضًا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الأخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. قوله: (أربعة أبيات) ليس عند ابن حبان والحاكم لفظ أبيات وفيه أن شهادة أربعة من جيران الميت من موجبات مغفرة اللَّه تعالى له. ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اللَّه الجنة فقلنا: وثلاثة قال: وثلاثة فقلنا: واثنان قال: واثنان ثم لم نسأله عن الواحد). قال الزين ابن المنير: إنما لم يسأله عمر عن الواحد استبعادًا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. قال الداودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. وقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أنس قال: (مر بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال: وجبت فقال عمر: ما وجبت قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار أنتم شهداء اللَّه في الأرض) هذا لفظ البخاري. وفي مسلم وجبت وجبت وجبت ثلاثًا في الموضعين. قال النووي: قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه. قالوا: والصحيح أنه على عمومه وأن من مات فألهم اللَّه تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلًا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة وهذا الإلهام يستدل به على تعيينها وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضح وأما في جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره وقد وقع في رواية من حديث أنس المتقدم: (إن للَّه عز وجل ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر).
1- عن ابن مسعود: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية). رواه الترمذي كذلك. ورواه موقوفًا وذكر أنه أصح. 2- وعن حذيفة أنه قال: (إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا إني أخاف أن يكون نعيًا إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينهى عن النعي). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 3- وعن إبراهيم أنه قال: (لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانًا فعل أهل الجاهلية). رواه سعيد في سننه. 4- وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد اللَّه بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمرة ففتح له). رواه أحمد والبخاري. حديث ابن مسعود في إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي عند أهل الحديث. وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي وقفه كما قال المصنف وقال: إنه حديث غريب. وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن وكلام إبراهيم الذي رواه سعيد بن منصور هو من طريق ابن علية عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم هل كانوا يكرهون النعي قال: نعم ثم ذكره. وروى أيضًا سعيد بن منصور بهذا الإسناد إلى ابن سيرين أنه قال: لا أعلم بأسًا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. قوله: (إياكم والنعي) النعي هو الإخبار بموت الميت كما في الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة قال في القاموس نعاه له نعيًا ونعيًا ونعيانًا أخبره بموته. وفي النهاية نعى الميت نعيًا إذا ذاع موته وأخبر به انتهى. فمدلول النعي لغة هو هذا وإليه يتوجه النهي لوجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه. وقال في الفتح: إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط: إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام انتهى. ويستدل لجواز مجرد الإعلام بحديث أنس المذكور في الباب فإن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بقتل الثلاثة الأمراء المقتولين بمؤتة وقصتهم مشهورة وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد اللَّه بن رواحة. وبحديث أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه) كما تقدم. وقد بوب عليه البخاري باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وبحديث أبي هريرة وغيره: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال عند أن أخبر بموت السوداء أو الشاب الذي كان يقم المسجد ألا آذنتموني) وقد تقدم. وفي حديث ابن عباس ما منعكم أن تعلموني. وقد بوب عليه البخاري باب الإذن بالجنازة. وبحديث الحصين بن وحوح وقد تقدم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت فهذه الأحاديث تدل على أن مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا وإن كان باعتبار اللغة مما يصدق عليه اسم النعي كما تقدم. ويؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي وابن سيرين كما سلف. وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتهى. ـ فالحاصل ـ أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي .
قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر. 1- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا وأنه كبر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبرها). رواه الجماعة إلا البخاري. حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر تقدم في الصلاة على الغائب وممن روى الأربع كما قال البيهقي عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانيًا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعًا ثم ثبت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على أربع حتى توفاه اللَّه تعالى). وكذا قال القاضي عياض وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعًا: (صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعًا) وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع انتهى. وقد اختلف السلف في ذلك فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسًا كما في حديث الباب وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا وروي أيضًا عن ابن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا. وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني عن عبد خير عنه. وروى ابن المنذر أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كبر على جنازة ثلاثًا. قال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحيح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى وقال علي ابن الجعد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع. رواه البيهقي. ورواه ابن عبد البر من وجه آخر عن شعبة. وروى البيهقي أيضًا عن أبي وائل قال: (كانوا يكبرون على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا فجمع عمر أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات). وروي أيضًا من طريق إبراهيم النخعي أنه قال: اجتمع أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في بيت أبي مسعود فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وروى أيضًا بسنده إلى الشعبي قال: صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فكبر أربعًا وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية. قوله: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبرها) استدل به من قال إن تكبير الجنازة خمس وقد حكاه في البحر عن العترة جميعًا وأبي ذر وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومحمد بن الحنفية وابن أبي ليلى وحكاه في المبسوط عن أبي يوسف وفي دعوى إجماع العترة نظر لأن صاحب الكافي حكى عن زيد بن علي القول بالأربع واستدلوا أيضًا بحديث حذيفة الآتي وبما تقدم عن جماعة من الصحابة قالوا والخمس زيادة يتحتم قبولها لعدم منافاتها وأورد عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خمس لأنها زيادة وقد وردت كما أخرجه البيهقي عن أبي وائل وقد تقدم ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة: الأول: إنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددًا ممن روى منهم الخمس. الثاني: إنها في الصحيحين. الثالث: إنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم. الرابع: إنها آخر ما وقع منه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: (آخر ما كبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على الجنائز أربع) وفي إسناده الفرات ابن سلمان. وقال الحاكم بعد ذكر الحديث ليس من شرط الكتاب. ورواه أيضًا البيهقي بإسناد فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف وقد تفرد به كما قال البيهقي. قال الحافظ: وروي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة. وقال الأثرم: رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. وقد سألت أحمد عنه فقال محمد هذا روى أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه. وقال: كان أبو المليح أتقى للَّه وأصح حديثًا من أن يروي مثل هذا وقال حرب عن أحمد: هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. وقال ابن القيم: قال أحمد هذا كذب ليس له أصل اهـ. ورواه ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن ابن عمر وفي إسناده زافر بن الحارث عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عنه. قال ابن الجوزي وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء ورواه الحارث بن أبي أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر بنحوه ويجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض ولا تعارض بين الأربع والخمس لأن الخمس مشتملة زيادة غير معارضة. وعن الرابع بأنه لم يثبت ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه وغاية ما فيه جواز الأمرين نعم المرجح الثالث أعني إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا المقام إن صح وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح. وفي المسألة أقوال أخر: منها ما روي عن أحمد بن حنبل أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع. ومنها ما روي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع. ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال التكبير تسع وسبع وخمس وأربع وكبر ما كبر الإمام روى ذلك جميعه ابن المنذر. ومنها ما روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما روى عنه ابن المنذر أنه قيل له إن فلانًا كبر ثلاثًا فقال وهل التكبير إلا ثلاث وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كبر ثلاثًا لم يزد عليها وروى عنه عبد الرزاق أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا فقالوا له يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا قال فصفوا فصفوا فكبر الرابعة. وروى عنه البخاري تعليقًا نحو ذلك وجمع بين الروايات عنه الحافظ بأنه إما كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة. 2- وعن حذيفة: (أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على جنازة فكبر خمسًا). رواه أحمد. 3- وعن علي: (أنه كبر على سهل بن حنيف ستًا وقال: إنه شهد بدرًا). رواه البخاري. 4- وعن الحكم بن عتيبة أنه قال: (كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا). رواه سعيد في سننه. حديث حذيفة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وفي إسناده يحيى بن عبد اللَّه الجابري وهو متكلم عليه والأثر المذكور عن علي هو في البخاري بلفظ: (أنه كبر على سهل بن حنيف) زاد البرقاني في مستخرجه (ستًا) وكذا ذكره البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور. ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن مغفل فقال خمسًا. وروى البيهقي عنه أنه كبر على أبي قتادة سبعًا وقال: إنه غلط لأن أبا قتادة عاش بعد ذلك. قال الحافظ: وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الراجح اهـ. وقول الحكم بن عتيبة أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه وقد تقدم الخلاف في عدد التكبير وما هو الراجح. وفي فعل علي دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه وكذلك في رواية الحكم بن عتيبة عن السلف وقد تقدم من فعله صلى اللَّه عليه وآله وسلم بصلاته على حمزة ما يدل على ذلك.
1- عن ابن عباس: (أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة). رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه: (فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق). 2- وعن أبي أمامة بن سهل: (أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًا في نفسه). رواه الشافعي في مسنده. 3- وعن فضالة بن أبي أمية قال: (قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب). رواه البخاري في تاريخه. حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم. وحديث أبي أمامة بن سهل في إسناده مطرف ولكنه قد قواه البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبد اللَّه ابن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعناه. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر وأخرجه أيضًا النسائي وعبد الرزاق قال في الفتح: وإسناده صحيح وليس فيه قوله (بعد التكبيرة) ولا قوله (ثم يسلم سرًا في نفسه) ولكنه أخرج الحاكم نحوها. ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس حديث آخر عند الترمذي وابن ماجه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) وفي إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جدًا وقال الترمذي: لا يصح هذا عن ابن عباس والصحيح عنه قوله (من السنة). وعن أم شريك عند ابن ماجه قالت: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ. وعن ابن عباس حديث آخر أيضًا عند الحاكم: (أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوته ثم صلى على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قال اللَّهم هذا عبدك وابن عبديك أصبح فقيرًا إلى رحمتك فأنت غني عن عذابه إن كان زاكيًا فزكه وإن كان مخطئًا فاغفر له اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم كبر صلاة تكبيرات ثم انصرف فقال أيها الناس إني لم أقرأ عليها أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة) وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو مختلف في توثيقه. وعن جابر عند النسائي في المجتبى والحاكم والشافعي وأبي يعلى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ فيها بأم القرآن) وفي إسناد الشافعي والحاكم إبراهيم بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. وعن محمد بن مسلمة عند ابن أبي حاتم في العلل أنه قال: السنة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثًا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك وقال: سألت أبي عنه فقال هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة. قال الحافظ: حديث حبيب في المستدرك من طريق الزهري عن أبي أمامة ابن سهل باللفظ السابق. قوله: (لتعلموا أنه من السنة) فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على مشروعية قراء فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد باللَّه ونقل ابن المنذر أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وإليه ذهب زيد بن علي والناصر وأحاديث الباب ترد عليهم. ـ واختلف الأولون ـ هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا فذهب إلى الأول الشافعي وأحمد وغيرهما واستدلوا بحديث أم شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق. قوله: (وسورة) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة ولا محيص عن المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح. ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاة. قوله: (وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يجهر بالليل كالليلية وذهب الجمهور إلى أنه لا يستحب الجهر في صلاة الجنازة وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم لم أقرأ أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة وبقوله في حديث أبي أمامة سرًا في نفسه. قوله: (بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة وقد أخرج الشافعي والحاكم عن جابر مرفوعًا بلفظ: (وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى) وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعيف جدًا. وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف. قوله: (ثم يصلي على النبي) فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة في الصلاة كحديث: (لا صلاة لمن لم يصل عليَّ) ونحوه. وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن أبي أمامة أنه قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة ثم يسلم. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى. قال الحافظ: ورجاله مخرج لهم في الصحيحين. قوله: (ثم يسلم سرًا في نفسه) فيه دليل على مشروعية السلام في صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه حكى ذلك في البحر. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: (ثلاث كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاة) وله أيضًا نحوه عن عبد اللَّه بن أبي أوفى فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة وتكون أيضًا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أبي أمامة بن سهل ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يصلي على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يرد ما يدل على تعيين موضعها والظاهر أنها تفعل بعد القراءة ثم يكبر بقية التكبيرات ويستكثر من الدعاء بينهن للميت مخلصًا له ولا يشتغل بشيء من الاستحسانات التي وقعت في كتب الفقه فإنه لا مستند لها إلا التخيلات ثم بعد فراغه من التكبير والدعاء المأثور يسلم وقد اختلف في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة فذهب الشافعي إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد اللَّه وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: إنه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط. وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها وقالت العترة بمنعه في كلها. احتج الأولون بما أخرجه البيهقي عن ابن عمر قال الحافظ بسند صحيح وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة. ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا وقال لم يروه عن نافع إلا عبد اللَّه بن محرر تفرد به عباد بن صهيب قال في التلخيص: وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعًا لكن قال في العلل: تفرد به برفعه عمر بن شيبة عن يزيد بن هارون. ورواه الجماعة عن يزيد موقوفًا وهو الصواب. وروى الشافعي عمن سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. وروى أيضًا الشافعي عن عروة وابن المسيب مثل ذلك قال: وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. واحتج القائلون بأنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال الحافظ: ولا يصح فيه شيء وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة رواه سعيد بن منصور اهـ. واحتجوا أيضًا بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى) وقال غريب. وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث. والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات ولا انتقال في صلاة الجنازة.
|